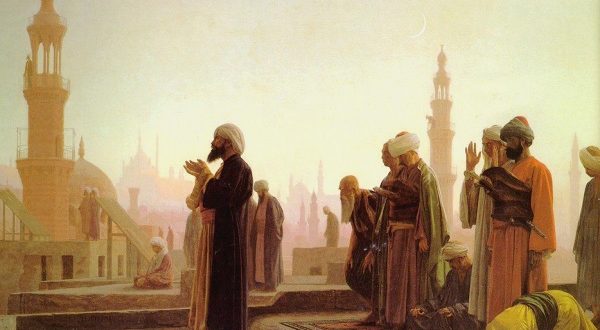كتب مصطفى قطب
في صفحات التاريخ الإسلامي، تلمع أسماء كبار الصحابة الذين كانوا مشاعل هدى، ومصابيح علم، وأوتادًا في نشر الرسالة السماوية بعد وفاة النبي ﷺ. ومن أبرزهم، الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، الذي لُقّب بـ”حَبر الأمة” و”ترجمان القرآن”، لما تميز به من علمٍ غزير، وفقهٍ عميق، وبصيرةٍ فذة في فهم كلام الله وسنة رسوله.
نشأ ابن عباس في أحضان الإسلام، ونهل من النبوة مباشرة، فأصبح أحد أبرز المفسرين والعلماء من الصحابة، وتولى مناصب في عهد الخلفاء، وكان مرجعًا في الفتوى والقضاء.
نشأته ونسبه:
عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي محمد ﷺ، وُلد في شعب بني هاشم بمكة المكرمة، قبل الهجرة بثلاث سنوات، أي في عام 3 قبل الهجرة (619م). والده هو العباس بن عبد المطلب، عم الرسول ﷺ، ووالدته هي أم الفضل لبابة بنت الحارث، وهي من أوائل النساء إسلامًا.
أسلم عبد الله بن عباس وهو صغير، لكنه نشأ على محبة النبي ﷺ والإسلام، وكان ملازمًا له، يراقب حركاته وسكناته، ويتعلم منه منذ نعومة أظفاره.
طلبه للعلم:
عُرف عن ابن عباس نهمه الشديد للعلم، وكان يحرص على تتبع كبار الصحابة ليسألهم عن الأحاديث والآيات. وكان يقول:
“إن كنت لأسأل الرجل عن الحديث الواحد ثلاثين مرة”.
وقد بارك له النبي ﷺ في علمه، ودعا له بقوله:
“اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل”
(رواه أحمد والترمذي)
وكانت هذه الدعوة سببًا في أن يصبح أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم، وهو ما دفع الصحابة أنفسهم للرجوع إليه في كثير من المسائل.
ملازمته للنبي ﷺ:
كان عبد الله بن عباس ملازمًا دائمًا للنبي ﷺ، حتى في أدق المواقف، وقد روى كثيرًا من الأحاديث النبوية، حتى قال العلماء إنه روى أكثر من 1600 حديث. ومن أشهرها حديثه عن النبي ﷺ عندما كان خلفه يومًا فقال له:
“يا غلام، إني أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك…”
(رواه الترمذي)
هذه الصحبة القريبة من النبي ﷺ صقلت شخصيته، وملأته بالحكمة والوقار، وفتحت أمامه آفاق التفسير والفهم.
علمه وتفسيره للقرآن:
لم يُلقّب عبد الله بن عباس بـ”ترجمان القرآن” عبثًا، فقد وهبه الله فهمًا عميقًا للآيات، حتى قال فيه عبد الله بن مسعود:
“نِعْمَ ترجمان القرآن عبد الله بن عباس”.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرص على إشراكه في مجالسه مع كبار الصحابة، رغم صغر سنه، ويقول:
“إنه فتى له لسان سؤول، وقلب عقول”.
وقد جمع الإمام الطبري وغيره العديد من أقواله في التفسير، وكانت تتميز بالفصاحة والدقة والاعتماد على أسباب النزول واللغة والسنة.
منزلته بين الصحابة:
رغم صغر سنه عند وفاة النبي ﷺ (كان يبلغ حوالي 13 عامًا)، إلا أن الصحابة الكبار كانوا يرجعون إليه، خاصة في عهد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد ولي ابن عباس الفتوى والقضاء في زمن عمر بن الخطاب، وأرسله علي بن أبي طالب واليًا على البصرة.
كما كان أهل الأمصار يبعثون إليه بالأسئلة في العقيدة والمعاملات والعبادات، وكان يجيب بعلمٍ وحجةٍ قوية.
زهده وورعه:
كان عبد الله بن عباس مثالًا في التواضع والورع، رغم علمه الواسع ومنزلته الرفيعة. وكان يقول:
“إنما العلم بالتعلم، والحِلم بالتحلم”.
وكان كثير العبادة، عميق التفكر، دمع العين، خاشع القلب، لا تغريه الدنيا ولا مناصبها، وكان يعيش للعلم والعمل.
موقفه في الفتنة الكبرى:
عاش ابن عباس أحداث الفتنة الكبرى بين الصحابة، وكان دائمًا يدعو للصلح والوحدة، ورفض المشاركة في القتال، وكان يُحاول الإصلاح بين المتنازعين. كما كان أحد المستشارين المقربين للإمام علي رضي الله عنه، وأرسله في عدة مهمات للتفاوض مع الخصوم.
وفاته:
توفي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الطائف سنة 68 هـ (687م) عن عمر ناهز 71 عامًا. وقد صلى عليه محمد بن الحنفية، ابن علي بن أبي طالب، وقال في تأبينه:
“اليوم مات حَبر الأمة”.
ودُفن في الطائف، وظلت ذكراه حيّة في قلوب المسلمين، وميراثه العلمي شاهدًا على مكانته حتى اليوم.
تراثه وأقوال العلماء فيه:
خلّف عبد الله بن عباس علمًا غزيرًا في الحديث، والتفسير، واللغة، والفقه، واعتبره العلماء أحد المراجع الكبرى في كل هذه المجالات.
قال الإمام الشافعي:
“إذا جاءك التفسير عن ابن عباس فحسبُك به”.
وقال الذهبي عنه:
“كان من أعلم الأمة بالقرآن والسنن، وواحدًا من أذكياء الصحابة”.
كان عبد الله بن عباس علمًا من أعلام الأمة، وجسرًا بين جيل النبوة وجيل الفقهاء، وحلقة وصل في نقل ميراث النبي ﷺ الخالد. جمع بين القرابة من الرسول، والصحبة، والعلم، والعمل، فاستحق أن يُخلد اسمه في التاريخ الإسلامي بحروف من نور.
إن سيرته تذكير دائم لنا بأن العلم فريضة، وأن القرب من أهل الحكمة والرسالة هو الطريق للرفعة في الدنيا والآخرة، فرحمه الله ورضي عنه، ورضي عن كل صحابة نبينا الأجلّ.
 المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة